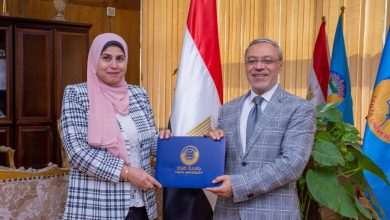ساره
في شوارع الإسماعيلية الهادئة، حيث تتلألأ أضواء سكن الطالبات كالدموع في عيون الحنين، كانت سارة حسن العدل تمشي بخطوات هادئة، عائدة من يوم دراسي طويل في كلية الألسن بجامعة قناة السويس. كان يومها الخامس عشر من فبراير، يومًا عاديًا يخلو من أي إشارة إلى النهاية الوشيكة. وفجأة، ومن حيث لا تدري، جاءت السيارة كالإعصار المدمر، تدهسها بعنف وتتركها مضرجة في دمائها، كوردة بريئة مزقتها يد الغدر.
كان عبد الرحمن وليد، الشاب السابع عشر، يقود السيارة بسرعة جنونية، دون اكتراث أو رحمة، وكأن الحياة لا تعني له شيئًا، وكأن روحًا بريئة لا تساوي شيئًا في ميزان حياته. نُقلت سارة إلى المستشفى، حيث خضعت لعمليات جراحية متعددة، لكن الأوان كان قد فات، والجراحات لم تكن سوى محاولات يائسة لإنقاذ ما لا يمكن إنقاذه. ظلت في العناية المركزة لأكثر من شهرين، تفاصيلها تنتهي، وقلبها يرفرف بين الحياة والموت، كطائر جريح يحاول الطيران بلا أجنحة.
في تلك اللحظات العصيبة، كان عبد الرحمن يتصرف باستهتار مريب، وكأنه يحتفل بالنصر على الحياة ذاتها. بعد خروجه بكفالة مالية، أقام احتفالًا تحت منزله، والطبل والمزمار يصدران أصواتًا ماجنة، كأنما يعلن انتصاره على براءة لم تكن تعني له شيئًا. نسي أو تناسى أن هناك أناسًا يعانون، أن هناك حياة قد زُهقت في ريعان الزهور، تاركة خلفها ألمًا لا يمحى.
قبل وفاة سارة بأسبوع، نشر عبد الرحمن صورًا احتفالية بعيد ميلاده على إنستجرام، وكأن لا شيء حدث، وكأن روحًا تُزهق كل يوم لا تعنيه. كان يحتفل بحياته، بينما كانت حياة سارة تتلاشى ببطء، كشمعة تنطفئ في ليلة حالكة السواد.
في 29 أبريل، فارقت سارة الحياة، تاركة وراءها أهلًا محطمين، وذكريات لا تمحى. أهلها يطالبون الآن بالعدالة، يريدون محاسبة عبد الرحمن على جريمته. يصرخون في وجه الظلم، مطالبين بالقانون أن يأخذ مجراه، ليكون درسًا لكل من تسول له نفسه العبث بحياة الناس.
سارة كانت طالبة مجتهدة، محبوبة بين زملائها، ترك فراقها فراغًا كبيرًا في قلوبهم. رحمها الله، وألهم أهلها الصبر والسلوان. العدالة وحدها من تستطيع أن تطفئ نار الحزن في قلوبهم، وتعيد لهم شيء من الطمأنينة المفقودة. العدالة هي النور الوحيد الذي يمكن أن يضيء دروبهم المظلمة، ويجعلهم يرون أن الحياة لم تعد ظلمًا محضًا.
تابعونا على صفحتنا الفيس بوك